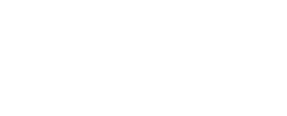يحتفل المصريون، اليوم الاثنين بعيد الفطر المبارك بعد 30 يوما من الصيام والتعبد فى شهر رمضان، وإتمامهم لفريضة الصيام حيث يميل العيد الذي يأتى في الأول من شهر شوال من كل عام وفق التقويم الهجرى، مناسبة دينية واجتماعية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام ويعد فرصة لتجمع العائلات وتبادل التهانى.
وسمي عيد الفطر بهذا الاسم لأنه متعلق بالإفطار في اليوم الذي يلي شهر رمضان المعظم مباشرة، وتُعدُّ مظاهر الاحتفال في مصر بعيد الفطر السعيد مختلفة، ولها طقوس تميزها عن بقية الشعوب العربية، حيث يحرص المصريون بعد أداء صلاة العيد، على تبادل الزيارات والتهاني، ثم التجمُّع العائلي على وجبة الإفطار في الساحات الكُبرى.
وفي هذا السياق ، قال عضو لجنة التاريخ والآثار في المجلس الأعلى للثقافة عبد الرحيم ريحان، إن العادات والتقاليد المرتبطة بالأعياد وتحتفظ بها الذاكرة الشعبية المصرية، وظلت حية باقية يتوارثها الناس من جيل إلى جيل، كثيرة جدا وفي مقدمتها، صلاة العيد.
وأضاف أن احتفالات عيد الفطر اتخذت صورًا شعبية ورسمية عبر العصور الإسلامية ففي العصر المملوكي كان يجتمع في صباح اليوم الأول أهالي الحى أمام منزل الإمام الذى سيصلى بهم صلاة العيد في المسجد فإذا خرج إليهم زفوه حتى المسجد وبأيديهم القناديل يكبرون طوال الطريق وبعد انتهاء الصلاة يعودون به إلى منزله على نفس الصورة نفسها التي أحضروه بها وذلك طبقًا لما جاء في دراسة أثرية لعالم الآثار الإسلامية الراحل الدكتور علي أحمد أستاذ الآثار والفنون الإسلامية.
وقال” يبدأ الاحتفال الرسمي بالعيد بصعود ناظر دار طراز الخاصة في آخر أيام رمضان إلى القلعة في موكب كبير وبصحبته عددًا عظيمًا من الحمالين يحملون خلع العيد لحملها إلى السلطان وفي ليلة العيد يدخل الأمراء جميعًا على السلطان لتهنئته وفى صباح يوم العيد ينزل السلطان إلى الحوش السلطاني لتأدية صلاة العيد ويسمع الخطبة بجامع الناصر بن قلاوون بالقلعة ويعود إلى الإيوان الكبير المشيد عليه حاليًا جامع محمد علي حيث يمد سماط حافل للطعام بلغت تكاليفه في بعض السنوات خمسين ألف درهم وأخيرًا يخلع السلطان على الأمراء وأرباب الوظائف كما يفرج عن بعض المساجين.
وأوضح أنه في العصر العثماني كان يبدأ الاحتفال الرسمي بعد فجر يوم العيد حيث يصعد كبار رجال الدولة إلى القلعة ويمشون في موكب أمام الباشا من باب السرايا (قصره) إلى جامع الناصر محمد بن قلاوون فيصلون صلاة العيد ويرجعون ثم يهنئون الباشا بالعيد وينزلون إلى بيوتهم فيهنئ بعضهم بعضا، وفي ثان أيام العيد ينزل الباشا للاحتفال الرسمي بالعيد حيث يجلس في الكشك المعد له بقراميدان (ميدان القلعة) وقد هيئت مجالسه بالفرش الفاخر والمساند الجميلة والستائر الفخمة وتقدم القهوة والمشروبات وقماقم العطور والبخور ويأتى رجال الدولة للتهنئة
وفيما يتعلق بالزيارات العائلية، قال ريحان “كان الناس يخرجون في أول أيام العيد بالقاهرة والمدن الأخرى إما إلى المقابر لتوزيع الصدقات رحمة على موتاهم، وصنع المصري القديم الفطير المخصص لزيارة المقابر في الأعياد والذى يطلق عليه حاليًا (الشريك) وكانوا يشكلونه على شكل تميمة ست (عقدة إيزيس) وهى من التمائم السحرية التي تفتح للمتوفي أبواب الجنة في المعتقد المصري القديم والبعض يذهب للنزهة في النيل وركوب المراكب ويذهب البعض الآخر لزيارة أقاربهم وأهلهم لتقديم التهنئة لهم”.
وحول طقوس كعك العيد، قال ريحان، “تعد صناعة كعك العيد في الأعياد من أقدم العادات التي عرفت عند المصريين القدماء وقد نشأت مع الأعياد ولازمت الاحتفال بأفراحهم وقد صنعوا أنواعًا عديدة من الكعك وكانت صناعة كعك العيد لا تختلف كثيرًا عن صناعته الحالية مما يؤكد أن صناعته امتدادًا لتقاليد موروثة وقد وردت صور مفصلة لصناعة كعك العيد فى مقابر طيبة ومنف”.
وأضاف” صوّر المصرى القديم طريقة صناعة الكعك على جدران مقبرة (رخمى – رع) من الأسرة الثامنة عشر وتشرح كيف كان يخلط عسل النحل بالسمن ويقلّب على النار ليضاف على الدقيق ويقلّب حتى يتحول لعجينة يسهل تشكيلها ثم يرص الكعك على ألواح من الإردواز ثم يوضع فى الفرن وكانت هناك أنواعاً تقلى فى السمن أو الزيت وكانوا يشكّلون الكعك على شكل أقراص وبمختلف الأشكال الهندسية والزخرفية وكان يشكّل بعض الكعك بأشكال الحيوانات وأوراق الشجر والزهور ويتم حشو الكعك بالتمر المجفف (العجوة) أو التين ويزخرف بالفواكه المجففة كالنبق والزبيب”.
وتعني كلمة “العيدية” في اللغة العربية العطاء أو العطف وترتبط بالعيد والعيدية لفظ اصطلاحي أطلقه الناس على كل ما كانت توزعه الدولة أو الأوقاف من نقود في موسمي عيد الفطر وعيد الأضحى كتوسعة على أرباب الوظائف وكانت تعرف في دفاتر الدواوين بـالرسوم ويطلق عليها التوسعة فى وثائق الوقف.
وبدأت عادة توزيع العيدية منذ العصر الفاطمي وكانت توزع مع كسوة العيد خارجًا عما كان يوزع على الفقهاء وقرّاء القرآن الكريم بمناسبة ختم القرآن ليلة الفطر من الدراهم الفضية وعندما كان الرعية يذهبون إلى قصر الخليفة صباح يوم العيد للتهنئة كان الخليفة ينثر عليهم الدراهم والدنانير الذهبية من منظرته بأعلى أحد أبواب قصر الخلافة.
وكانت العيدية تسمى في عصر المماليك “الجامكية” وتم تحريفها إلى كلمة العيدية وكان السلطان المملوكي يصرف راتبًا بمناسبة العيد للأتباع من الأمراء وكبار رجال الجيش ومَن يعملون معه وتتفاوت قيمة العيدية تبعًا للرتبة فكانت تقدم للبعض على شكل طبق مملوء بالدنانير الذهبية وآخرون تقدم لهم دنانير من الفضة وإلى جانب الدنانير كانت تقدم المأكولات الفاخرة.
وطالب ريحان بتقليد جديد يرتبط بالعيدية دائمًا لربط الأطفال بتاريخهم وهويتهم فحين يعطى الآباء العيدية لأبنائهم يلفتوا نظرهم إلى القيمة المعنوية الحضارية للعملة المصرية التي تحمل صورًا لأعظم آثار العالم حيث يشرف الجنيه المصرى بصورة معبد أبو سمبل الذي بناه الملك رمسيس الثاني في الأسرة التاسعة عشر لزوجته نفرتاري والخمسة جنيهات تحمل صورة معبود النيل حابى رمز الخير والنماء وكان تلويث النيل من الذنوب العظمى فى مصر القديمة وتحمل العشرة جنيهات صوره تمثال الملك خفرع صاحب الهرم الأوسط وتمثال أبو الهول وتحمل العشرون جنيهًا صورة العجلة الحربية السلاح الحربي الفتاك الذي انتصر به الملك أحمس الأول وطرد به الهكسوس من مصر في الأسرة الثامنة عشر.
وفيما يتعلق بأكلات المصريين في العيد، قال ريحان، كان المصريون فى العصر المملوكي يفضلون أكل السمك المشقوق أي السمك المجفف البكلاه، وكعك العيد بأنواعه وهناك عادة جميلة عشناها في طفولتنا وهى حرص المسلمين على إهداء المسيحيين المجاورين لهم والأصدقاء كميات من هذا كعك العيد للمشاركة فى الفرحة ويحرص المسيحيون فى أعيادهم على هذه العادة التى تؤكد ترابط نسيج الأمة دائمًا وكنا نفرح كأطفال بتناول الكعك طول العام والتنزه مع شركاء الوطن في كل الأعياد وحتى في عيد السعف أو الشعانين كنا نصنع مفردات السعف ونسير مع الأطفال فرحين بهذا المظهر الجميل والذى أصبح جزءًا من الذاكرة الوطنية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)